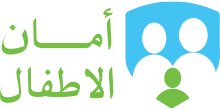احتفاء بأسبوع الأسرة، يتابع موقع "أمان الأطفال" نشر سلسلة موضوعات تتعلّق بهذه المناسبة، والتي بدأت فعاليتها يوم أمس.
تغيب عن أسرنا الاجتماعيّة مفاهيم مهمّة للغاية في العمليّة التربويّة، ألا وهي الاهتمام بموضوع القيم الجماليّة والجمال المعنوي للأسرة فالحديث عن الجمال حقيقةٌ واقعة، في هذا العالم، لا يمكن لعاقلٍ إنكارها، ويكمن الجمال حولنا في كلّ شيء، فهو يوقظ المشاعر والأحاسيس الإنسانيّة في داخلنا، ويجعلنا نرى ما حولنا جميلًا. قي هذا الصدد، يكتب الشيخ حسن الهادي، مدير مركز الدراسات الثقافيّة في جمعيّة المعارف مقالا جميلًا ومفيدَا ؛ يقول :
"للجمال مساران، أحدهما ماديّ وله ضوابطه، والآخر معنويّ ليس له حدود، والماديّ نوعان- أيضًا- أحدهما دنيويّ والآخر أخرويّ؛ فالجمال الدنيويّ تراه في الإنسان وفي الحيوان والجماد، وحدوده ألّا يثير شهوة الإنسان فيما حرّمته الشريعة الإسلاميّة.
أمّا الجمال المعنويّ الذي يكتسبه الإنسان في الدنيا فهو الجمال الذي يزيّن الإنسان من الداخل ويجعله قريبًا من الله عز وجل؛ لأنه سيتشبّع بمعاني الروح، ويزيّن القلوب بالتقوى والأخلاق الفاضلة. وهذا الجمال محبوب ومرغوب، ومن آثاره العمليّة المباشرة تأليف القلوب، وتحبيب النفس للآخرين، وبالتالي تحقيق المقصد التعبّدي فيما آتاه الله للإنسان من فضيلة، حيث يستثمر ذلك الحُسن في التأثير الإيجابيّ الحسن ببيئته ومحيطه.
فالجمال ليس في الشكل الظاهريّ فقط، إنّما هو في المقام الأوّل في أعماق النفس الإنسانيّة، ويرتبط الإحساس بالجمال بالتفاؤل، والإقبال على الحياة، والاتجاه إلى عمل الخير... ومن أجل ذلك كان حرص الإسلام على تربية الذوق الجمالّي لدى الإنسان المسلم.
من المؤسف أنّنا عندما نمعن النظر في واقع كثير من المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة، نجد بأنّ التعامل مع الجمال اليوم أصبح على المحكّ، حيث أصبح المسلمون يتّبعون مختلف أساليب التزيّن الجسديّ والموضة والموديلات الفاضحة، ويستخدمون جميع أنواع الألبسة الوافدة، وأدوات الزينة الفاقعة، وكأنّها في قمّة الجمال، بينما إذا ذهبتَ إلى الروح فإنّك تجدها خاوية من أيّ جمال وفارغة من أيّ مضمون وزينة، فما بال من زيّن نفسه من الخارج وهو يحمل في داخله خواء وفراغ إلّا مِنْ ما اصطلح عليه موضة ومودرن وصرعات في اللباس والشكل...
الأخطر من ذلك كلّه أنّ هذا السلوك الذي نخر في صلب مجتمعاتنا أدّى إلى تعرّض المنظومة القيميّة العامّة إلى هزّات وتحوّلات، فانتابت المجتمعات البشريّة حال من الإحباط والعجز والقلق والتوتر وعدم الرضى، وشاعت بين الناس حالات من التردّي التربويّ والاجتماعيّ، وسادت الفوضى الأخلاقيّة والسلوكيّة، وظهرت حال من «اللامعياريّة» التي يضيع معها الشعور بالانتماء، ومن ثمّ تظهر أنماط معاكسة من القيم السلبيّة المختلفة في السلوك الفرديّ والاجتماعيّ.
لم نقصد من هذا المدخل حول الجمال إلا التأسيس لمجموعة من المبادئ والقيم التي يجب العمل على تحويلها إلى برامج ثقافيّة وتبليغيّة وتربويّة من منطلق نظرتنا وفهمنا للجمال وكيفيّة التعامل معه وعيشه في السلوك الفرديّ والاجتماعيّ بالاستناد إلى قيمنا الإسلاميّة المنسجمة مع الفطرة الإنسانيّة، إلى جانب الوقاية ومواجهة الثقافة الوافدة. ولهذا نشير في هذه العجالة إلى مجموعة من التحدّيات التربويّة والثقافيّة الداهمة التي لم يعد بالإمكان السكوت عنها، والإشارة بإيجاز إلى ما يمكن العمل عليه لمواجهتها، وهي:

1- العمل العلميّ الجادّ على توجيه المجتمع وتحذيره من الثقافات الغربيّة الوافدة التي تغلغلت في أسلوب حياة الناس وسلوكهم وثقافتهم بكلّيّاتها وجزئيّاتها على السواء، ولا سيّما فيما يتعلق بظاهرة الموضة وتنوّع الموديلات والتجمّل المتفلّت من كلّ الضوابط، وما يترتّب عليها من آثار سلبيّة قبيحة. أصبحنا نرى آثارها في المجتمعات الغربيّة، بشكل واضح وجليّ، وتتمثّل في جرائم الاغتصاب والميوعة والانحلال والشذوذ واللائحة تطول...
2- التحذير مما ذهبت إليه التيّارات الفكريّة الغربيّة من أنَّ الأسرة شكلٌ من أشكال السيطرة الأبويّة السّلطويّة، وأنَّ شرط الإبداع والتجاوز يكون من خلال التمرّد على كلّ أشكال الأبويّة؛ ومنها الأسرة.
3- الالتفات إلى التغيّرات الواسعة التي شهدها العالم في مجال العلاقة بين مكوّنات الأسرة، حيث فقدت الأسرة في كثير من المجتمعات، وإن بدرجات متفاوتة، مفهومها في الطبيعة الفطريّة، وموقعها في البناء الاجتماعيّ، ووظيفتها في التنشئة والتربية، كلّ ذلك لصالح اتجاهات فردانيّة، تُعْلي من قيمة الفرد، وتجعلُه بؤرةَ الاهتمام، وتَحُدُّ من دور الأسرة في تشكيل بنيته النفسيّة والعقليّة. ولم تكن الأسرة العربية والإسلاميّة بمنأى عن هذه التغيّرات؛ وبذلك اضطرب مفهوم الأسرة؛ فشاع مصطلح الشريك والقرين، ووُصِف الزواج الطبيعيّ بالتقليديّ أو النمطيّ، وظهرت دعوات إلى بناء الأسرة غير النمطيّة، أي على الطريقة الغربيّة، مع ما فيها تفّلت من القيم والدّين.
4- ثمة تيارات تنادي بالتطابق أو المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، من دون مراعاة لما أودعه الله عزَّ وجلَّ من خصائص فطريّة ونفسيّة وجسميّة لكلا الصنفين؛ فانتشر ما يسمّى بالحركات النسويّة، وبرز مفهوم النوع الاجتماعيّ "الجندر" تجلّيًا واضحًا للقضاء على سمات التفرُّد والتمايز الطبيعيّ بين الجنسين. ولعلَّ انتشار مصطلح الأمّ العزباء في البنية المجتمعيّة الغربيّة، يشير إلى تآكل مؤسّسة الزواج؛ وسائر مفاهيم الرابطة الأسريّة المتأصّلة في البناء التشريعيّ للديانات السماويّة. وقد حاولت المؤتمرات الدوليّة أن تغذّي هذا الإحساس بالتمرُّد، والتفلُّت من القيام بالمسؤوليّة الأدبيّة والأخلاقيّة تجاه الأسرة، بإعطاء الشرعيّة للقوانين التي تقوّض عُرى الأسرة؛ مفهومًا وبناءً ووظيفةً.
5- للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ دور كبير في تغيّر مفهوم الأسرة في عالمنا العربيّ والإسلاميّ، وغدت الأفلام والمسلسلات الغربيّة أو المستغربة وما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعيّ تؤدّي المهمّة التي كان على الأسرة أن تؤدّيها في إحداث التنشئة الاجتماعيّة والتربية على القيم الصالحة والفضائل النبيلة، ومن ثم أصبحت تلك البرامج الإعلاميّة مصدرًا لإنتاج القيم والمعايير الاجتماعيّة، التي تتناقض والبنية المعرفيّة الإسلاميّة، ما أثّر سلبًا في شخصيّة الفرد المسلم، فانحرفت العلاقات بين الجنسين عن الصورة التي كانت تقتضيها الفطرة البشريّة والأعراف الاجتماعيّة والأحكام الشرعيّة.
بناءً على ما ذكر من تحدّيات ينبغي إعطاء الأولويّة للعمل على:
1- تعزيز التربية الوالديّة الإيجابيّة المستمرّة والمواكبة لتفاصيل حياة الأبناء ولا سيّما الفتيات، ما يرسّخ في نفوسهم قيم العفّة والحياء والاحتشام منذ الصغر. فالتربية الوالديّة يجب أن تتطوّر برامجها لإعداد الشباب والشابات قبل الزواح وبعده، للقيام بالمهمّة الإنسانيّة المقدّسة التي تتطلبّها مسؤوليّة البناء السليم للأسرة، وقيامها بمهمّتها في تربية الأبناء وتنشئتهم، بصورة تعزّز لديهم قيم الانتماء للمجتمع والأمّة، وتوفّر لهم القدوة الحسنة في استلهام هذه القيم وتمثّلها، وتتيح لهم البيئة الغنيّة التزوُّدَ بأنماط التفكير السليم، والسلوك القويم، والمعرفة الحقّة، والخبرة الوفيرة.
2- استلهام موقع الأسرة ومكانتها في البناء الاجتماعيّ، في ضوء الوحي الإلهيّ والهدي النبويّ؛ لتتمكّن من التربية على قيم الإسلام وفضائله.
3- الفهم العلميّ القائم على البحوث النظريّة والدراسات الميدانيّة لطبيعة التغيّرات التي طرأت على الأسرة وموقعها في المجتمع الحديث والمعاصر؛ كي نتمكّن من تشخيص التحدّيات التربويّة التي تواجه الأسرة المسلمة في الوقت المعاصر، والحدّ من تأثير الاستلاب والاختراق الثقافيّ.
4- حماية الأسرة في المجتمع العربيّ المسلم من الآثار السلبيّة للعولمة والحداثة والتيّارات الفكريّة الغربيّة، وإبراز خطورة التشريعات الغربيّة والمتغرّبة والعالميّة الخاصّة بالأسرة على الخصوصيّات الثقافيّة لهذا المجتمع.
5- تعزيز دور الأسرة الممتدّة وضرورتها في بناء الشخصيّة الإنسانيّة المتوازنة والمتكاملة؛ أسرة النسب والصهر، وأسرة البنين والحفدة.
6- العمل على وضع برامج ومشاريع تربويّة وإعلاميّة واجتماعيّة وتفعيلها، وإعداد خطط عمليّة للنهوض بالدور التربويّ الفاعل للأسرة.
ختامًا:
لم يكن ذكر الصور الجماليّة البديعة، في القرآن الكريم، وصفًا دقيقًا وحقيقيًّا للكون، بما فيه من كائنات ومن فيه من البشر، إلّا ترسيخًا لقيمة الجمال في النفوس، وتربية للذوق الجماليّ لدى الأفراد والجماعات، الأمر الذي من شأنه أن يرقّق المشاعر ويرهف الإحساس ويعّمق الإدراك. وليس هناك من شكّ في أنّ ذلك كلّه ينعكس بصورة إيجابيّة على سلوك الإنسان في الحياة، ويجعله سلوكًا مدنيًّا وحضاريًّا مجسّداً للقيم التي تحي الجمال المعنوي للأسرة وترسم ملمح الجمال والجلال فيها.
مواضيع مرتبطة
إفراط الأم في الخوف على الأبناء.. مسألة صحية أم مرضية؟
الحقيقة القاسية، هي أن مثل هذه الأم لا تهتم بالطفل، بل بخوفها من أن تبقى بلا شيء.
تربية الأبناء تتلخص في كلمتين: النحل والنمل.. كيف؟
كان مجتمعنا في كثير من الأوقات يكثر فيه النقد والمقارنة واللوم، إن تركناها وحاربناها نستبدلها بماذا؟
ليبيا: إدمان الأطفال على الإلكترونيات يُقلق الأسر
تغيّرت سلوكيات أطفالي على صعيد العصبية والقلق في النوم والحديث خلاله.