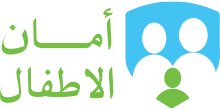.jpg)
خاص "أمان الأطفال"/ د. شوكت اشتي
الطفل المؤذي هو الطفل الذي يؤدّي سلوكه إلى إلحاق ضرر ما، في الآخرين، أو في ما يُحيط به من حياة، أو جماد، الأمر الذي يُثير قلقًا في محيطه الأضيق، وتوترًا مع البيئة التي يعيش فيها. إذيجعل علاقته دائمة الاضطراب مع بيئته وناسها. ضمن هذا التصور، يغدو الطفل المؤذي عدوانيًّا تجاه الغير، ويتسم سلوكه عادة بالعنف، وسرعة الغضب.
منطلقات أوليّة
الطفل أبن بيئته، والتنشنئة المجتمعية هي التي تُشكله، وترسم معالم شخصيته، وتكّون طباعه بحسب الإطار الثقافي للمجتمع الذي يولد، ويعيش فيه، من حيث المبدأ. من هنا؛ ضرورة البحث في الأسباب الموجبة، أو المحفزة التي قد تدفع هذا الطفل، وليس غيره من الأطفال، للسير بالاتجاه المعاكس للسائد سلوكيًا، ومُخالفًا للقواعد والأصول المُغترض إتباعها في هذا المجتمع.
وعليه؛ فالطفل المؤذي هو عدائي، عُنفي، يستخدم القوة، من حيث المبدأ، استخدامًا غير مشروع،أو مقبول، أو أنّ تصرفه يبدو غير مطابق لما هو متعارف عليه. هذا التوصيف، قد يُثير العديد من التساؤلات، حول طبيعة هذا الطفل من جهة، والعوامل التي تدفعه كي يغدو مؤذيًّا، ومُضرًا من جهة ثانية، والمعايير التي يمكن على أساسها الحُكم عليه بهذه النعوت والأوصاف من جهة ثالثة. بمعنى آخر، هل الطفل المؤذي هو بالفطرة مؤذيًا؟ هل يولد الطفل مؤذيًا/عدوانيًا؟ أم أن هناك عوامل تؤدي به إلى هذا المسار؟ وفي الحالات كافة، هل يمكن التفكير بالوسائل، أو الأساليب التي من خلالها يمكن تخفيف حدة هذا السلوك وتداعياته.
عوامل متداخلة
بعيدًا عن موضوع "الجينات"، والعوامل الوراثية، والأمراض التي قد ترافق الولادة (ضطراب ذهني، مرض عضوي، خلل في الهيرمونات...)، لأنّ هذه الوضعيات تتطلب، من حيث المبدأ، مقاربة أخرى، وتحتاج إلى أطباء، فالطفل المؤذي يكتسب الأذية، ويتعلم العدوانية، ويعتاد على الصراخ، وسرعة الغضب.... من خلال مسار حياته، خاصة في مراحل عمره الأولى.
من هنا تتداخل مجموعة من العوامل وتتفاعل في مسيرة حياتية، وتحت ظروف معينة، لتدفع هذا الطفل دون غيره، باتّجاه السلوك المؤذي. وعليه، يمكن القول، إن البذور الأولى لتشكيل الطفل المؤذي، نجدها، مبدئيًا، في بيئه الأسرية، والعائلية، ومحيطه الأوسع، والمدرسة التي يتعلم فيها، والعلاقات الاجتماعية التي ينسجها، والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتصفحها.... ولكل من هذه المجالات المتعددة، مجموعة من العناوين الفرعية، والتفاصيل الجزئية التي تسهم في تنمية الميول العدوانية في شخصية الطفل.
تعاون وتكامل
على مستوى الأسرة، قد لا ينتبه الأهل، في زحمة الحياة التي نعيشها، وخاصة في ظل الظروف غير الطبيعية التي نمر بها، سياسيًا، واقتصاديًا، ومعيشيًا، واجتماعيًا....، إلى طبيعة تعاملهم مع الأبناء، وطرائق التواصل معهم، ومقدرتهم على فهمهم، وتلبية حاجاتهم... وقد يعتمد البعض على العقاب والقصاص، والحرمان من أبسط المتطلبات الحياتية، بحجة تصحيح الأخطاء التي يرتكبها الأبناء، أو بحجة تربيتهم التربية الأفضل، لتقويم سلوكهم، وتعليمهم على الأفضل...
قد يلجأ البعض، وفي العديد من الأوقات، إلى التمييز بين الأبناء، قصدًا، أو من دون قصد، خاصة، عندما يُحقق أحدهم إنجازًا دراسيًا، أو عملاً محددًا، والتقليل من شأن الآخر، أو التشهير به، عند كل خطأ، ومقارنته بالآخرين، وتجاهل ما يُحققه، أو يسعى جاهدًا لتحقيقه،..... كما أن طبيعة العلاقة بين الأم والأب، غير الصحية في بعض الأحيان، لجهة الصراخ، والعصبية، وعدم الاحترام المتبادل، وتضخيم المشاكل، وتحميل الأبناء، صعوبات الحياة التي يعانون منها، والإنخراط في الخلافات لأبسط الأسباب.... تسهم، وإلى حد كبير، في "شحن" الطفل بطاقة، يمكن تفريغها بطرق غير سليمة. لأن غياب الحوار المشترك في البيت، يؤجل "الإنفجارات"، لكن لا يُلغيها.
أما على مستوى المدرسة، فأنه قد تتضمن شقين، الأول، علاقة الأهل بالمدرسة. والثاني، البيئة المدرسية بحد ذاتها. في الشق الأول، يعتقد بعض الأهل أن مجرد تسجيل الأبناء في المدرسة، إنتهت مهمتهم. وعليه، فهم لا يتواصلون مع الإدارة، وقد يتخلفون عن حضور اجتماعات المشتركة بين الهيئة التعليمية والأهل، ولا يتعرفون على أصدقاء الأبناء، وزملائهم...، مما يوسّع مساحات الإنفصال بين الطرفين، ويجعل الأهل والأبناء كل في عالمه. فلا الأهل يدركون، عمليًا، أوضاع الأبناء، ومشاكلهم، وهمومهم، ومعاناتهم، وما قد يواجهونه من أزمات....، ولا الأبناء لديهم من يوجّه، ويتابع الخطوات، ويهتم بالتفاصيل، ويقوم الأخطاء.... خاصة وأن بعض الأهل لا يهتم، ولا يسأل إلا عن النتيجة النهائية للطفل في المدرسة، الأمر الذي قد يُشعر الطفل، بأنه "منبوذًا"، أو "رقمًا"، أو "حملاً" ثقيلاً على الأهل.
أما في الشق الثاني، فبعضنا، قد لا يهتم، كثيرًا، بطبيعة المدرسة بحد ذاتها. ومن الواضح إن الأوضاع التعليمية الصعبة التي نمر بها في هذه السنوات، همشت، في بعض المدارس، دورها التربوي. وقد لا نهتم كثيرًأ، أو لا نتابع، طبيعة النمط الإداري في المدرسة، وطرائق التعليم، وتصرفات المعلمين، وإدارة الصف، ومجريات ما يجري في الملعب، وطريقة تعامل بعض المعلمين مع التلاميذ، وتصيد الأخطاء وتضخيمها، والتشهير بهم عن ارتكابهم بعض الهفوات، أو حصولهم على علامة متدنية، وتجاهل قدراتهم...، إضافة لما قد يتعرض له بعض التلاميذ من تنمر، واستهزاء....، وغيرها من المسائل، قد تدفع الطفل إلى كبت مشاعره، و"تخزين" إنفعالاته التي سرعان ما يتم التعبير عنها، سلوكًا عدوائيًا، ومؤذيًا عندما تسمح الفرصة.
المحيط والصحبة
يؤدّي المحيط الاجتماعي، والصحبة التي تُحيد بالطفل دورًا مهمًا في تنمية مشاعر الغضب، والسلوك العنفي. لأن العلاقات بين مجموعة الصحبة، والنماذج التي يحاولون تجسيدها في تصرفاتهم، والتنافس بينهم لإبراز القوة، والتفوق، والتمايز،.... ومحاولات إثبات الشخصية، والتماهي مع بعض النماذج "الذكورية" في المجتمع.... قد تكون من المنطلقات الأولية، لتنمية مشاعر إثبات الذات، عبر العنف وإلحاق الأذى بالغير. خاصة، وأن بعض الأطفال قد يكون ضعيفًا داخل مجموعة الصحبة، وغير قادر على مواكبة غيره، كما قد يعاني من نقص في المهارات المطلوبة...، ما يولد لديه المزيد من الإحباط، الأمر الذي قد تكون أذية الأخر متنفسًا، للتعويض عن ضعف الشخصية، ومحاولة إثبات قوتها وسطوتها.
كما أن ما تتناقله وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، من أفلام عُنفيّة، ومظاهر سلوكية غير سوية...، قد تجعل الطفل يقتدي بأبطالها، ويعمل على تحويل هذه المشاهدات إلى سلوك عدواني، مؤذٍ. غير أنه من الضروري الإشارة، إلى أن الأزمة، هنا، ليست في وسائل التواصل الاجتماعي. كما يعتقد البعض، أو كما يتم الترويج لهذه المقولة. لأن في هذا المنحى نوع من التهرب من المسؤولية. خاصة وأن هذه الوسائل أصبحت من مستلزمات الحياة اليومية، وفوائدها واضحة وجلية. لذلك لا ضرورة للبحث عن التقصير، من خلال إلقاء اللوم على الآخر، في موضوع "إنحراف" الأطفال، وخروجهم عن المقبول اجتماعيًا. لأن المطلوب متابعة وضع الطفل، ومساعدته للخروج من أزمته.
مظاهر التعبير
في إطار هذا الفضاء الضاغط الذي يعيشه الطفل، فقد لا يكون من الصعوبة ملاحظة ردات فعله الأولية، قبل المباشرة بالسلوك العدواني، وإلحاق الأذى بالآخرين؛ لأن الطفل في هذه الوضعية، يكون سريع الإنفعال، شديد الغضب. من هنا يمكن ملاحظة مدى توتره من تعابير الوجه، وحركة الجسد، وإستخدام الألفاظ العنفية، والنابية، وكثرة تحريك اليدين، والتلويح بهما....
إن هذه المظاهر، وغيرها، قد تغدو جزءًا أساسيًا من شخصيته، سرعان ما تتوضح، وتُفصح عن ذاتها. لدرجة إن هذه المظاهر، تُصبح مؤشرات تسبق ردات الفعل العنفية التي يلجأ إليها، الأمر الذي قد يجعل هذه المؤشرات "جرس الإنذار"، لمن حوله، والمحيطين به، ما قد يجعلها مدخلاً لمعالجة الموقف المتفجر، قبل حصول "الكارثة".
نوافذ وآفاق
إن تعدد العوامل المُحركة للسلوك المؤذي عند الطفل، وإن تعددت مجالاتها، فقد تتقاطع، مبدئيًا، حول بعض العناوين الرئيسة، من السخرية والإهمال والإحباط وقلة الاهتمام وسوء التكيف والشماته والغيرة والحرمان والكراهية، وضعف الشخصية،....، وغيرها العديد. غير أن هذا التعدد لا يعني أن "المعالجة"، مسألة مستحيلة، وإن كانت مُعقدة. كما لا يعني، بالضرورة، أن من يتعرض لبعض هذه الوضعيات، يتحول بالضرورة إلى طفل مؤذي. لأن المسألة ليس معادلة حسابية، أو تجربة في مختبر.
لذلك؛ المتابعة، لـ"ـمعالجة" وضعية الطفل المؤذي ليست "وصفة طبية"، بل هي علاقات اجتماعية، في أجواء من المحبة، والتفاعل والمشاركة والتفهم، والتفاهم. وهي تنبع من الداخل، فكرة، ورغبة، للتتجسد في الحياة اليومية في العلاقة بين الأهل والمحيط والطفل. من هنا؛ مراجعة مسار نمو الطفل، وعلاقتنا به، والسعي لفهمه، ومعرفة أوضاعه، وإحتضانه، وفتح المجالات أمامه للتعبير عن ذاته، وسماعه، وتشجيعه على الإفصاح عن مشاعره، والإبتعاد عن الضغط، بكل أنواعه، وعدم التعامل معه على أنه "جنديًا عليه التنفيذ دون المناقشة،..... هي من المداخل الأساسية لـلوصول إلى "بر الأمان"؛ خاصة وأنه من واجبنا، بل من المفروض علينا، المربون والأهل، أن لا نكون مزاجيين في تعاملنا مع أطفالنا، سواء في البيت، أو في المدرسة، أو في الإطار المجتمعي الأوسع.
كما علينا أن نُدرك، ونعي، ونستوعب أن الطفولة، مرحلة عمرية، باقية ومستمرة، لكن المفاهيم تغيرت، وتبدلت، وطرائق التعامل تنوعت وأصبحت أكثر غنى..... فهل يمكن فهمها، لنكون أكثر مقدرة على مواكبتها؟ أنه التحدي الدائم أمامنا نحن الأهل والمربون.
مواضيع مرتبطة
كيف يؤثر العقاب البدني على صحة الأطفال وتطورهم الذهني؟
تؤكد الأدلة العلمية الحديثة أنه يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على الأطفال
هل تؤثر الأنشطة التكنولوجية على معدل سعادة المراهِق وما هي البدائل؟
يقضي «جيل ما بعد الألفية» وما بعدها وقتًا أقل مع أصدقائهم وجهًا لوجه، بينما يقضون وقتًا أطول على الإنترنت.
كيف تعرفين أن طفلك لديه مشكلات نفسية؟
عزيز ثقة الطفل بنفسه العلاج المبكر يساعد في التكيف مع مشكلته، وتطوير مهاراته بشكل طبيعي،